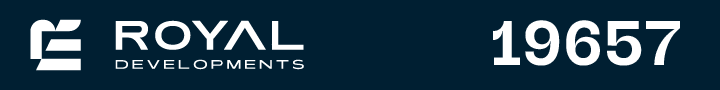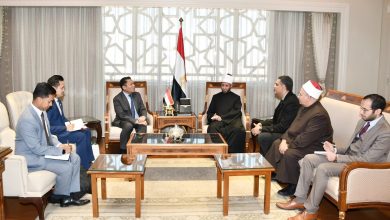د. يسرى عبدالغنى يكتب : قَضِيَّةُ المُوَازَنَةِ بَيْنَ الشُّعَرَاءِ وَتَجَلَّيَّاتِهَا فِي النَّقْدِ العَرَبِيِّ القَدِيمِ
برزت في النقد القديم قضية الموازنة بين الأشعار، وبين الشعراء، بوصفها آلية نقدية، ومنهجا بحثيا، يراد منه ترجيح كفة على آخرى، ولأهميتها فقد ظهرت في مرحلة مبكرة في تاريخ الأدب العربي.
وبقيت كذلك إلى اليوم، ويأتي هذا المقال محاولا تناول تجليات هذه القضية في الدرس النقدي القديم، وكيف اعتمدها النقاد في المفاضلة بين الشعر والشعراء، وما هي أوجه الاختلاف في رؤية كل واحد منهم لهذه القضية.
ولعل أهم النتائج المتوصل إليها: أن الموازنة منهج علمي أصيل استفاد منه النقاد القدماء وحاكموا من خلاله الشعراء إلى معايير دقيقة ساهمت في المفاضلة بينهم، ويظهر الآمدي والقاضي الجرجاني كأهم هؤلاء النقاد الذين اعتمدوا الموازنات منهجا نقديا في مؤلفاتهم.
ظهرت موازنة الآمدي (ت 37هـ)(1) بين شعر أبي تمام وشعر البحتري في ظروف زمنية خاصة؛ بعدما امتزجت الحضارة العربية الإسلامية بالحضارات الأخرى الوافدة عليها، وبعدما صار النقد يستعين بأدوات فنية جديدة ساهمت في حلِّ كثير من المسائل النقدية، وكان الشعر قد تأثر أيضا بالظروف الجديدة التي ميَّزت العصر العباسي لما طرأ عليه من تغيير في شكله ومضمونه، لاستجابة الشاعر العباسي للذوق الجديد في عصره، ونزوعه إلى التزود بجميع ألوان المعرفة، فكان يتمثل هذه الألوان ويحيلها إلى واقع شعري بديعي، تجلى ذلك في اعتناء بعض الشعراء بالصور اللفظية، وبالمحسنات البديعية، وبالمعاني العميقة، وبالغموض والإغراب والمبالغة.
وكان النقد في تلك الفترة قد أوْجَسَ خِيفةً من حركة التجديد التي ظهرت في الشعر، والتي بدت سريعة الخطوات بعدما رادها “ابن هرمة، وابن ميادة وبشار، وتسلم الراية خفاقة أبو نواس وأبو العتاهية، ثم أتى من بعد هؤلاء مسلم بن الوليد ليأخذ بيد تلميذه أبي تمام”(2)، فقسّم النقاد الشعر إلى قديم ومحدث، وجعلوا أبا تمام مُمثل الشعر المحدث، وجعلوا البحتري ممثل الشعر القديم
الموازنات الشعرية، والموازنة تمثل إحدى صورتي الحكم النقدي، ذلك أن الناقد- حين يحكم- إما أن يصدر حكمًا غير قائم على موازنة، فيقول هذا الشعر جيد، أو هذا الشعر رديء.
الموازنة بين القصائد في نونية ابن زيدون :
بدأ ابن زيدون نونيته بشكوى البين والأعداء والزمان، وكانت الأبيات السبعة التي تحدث بها عن جواه زفرة محرقة لم يَعبها ما وشيت به من الزخرف، ولكن أين هي من بداية شوق حين خاطب الطائر الحزين في وادي الطلح بضاحية إشبيلية؟ لقد تمثل الطائر شبيهًا به في لوعته وجواه فاندفع يقول:
يا نائِحَ الطَّلْحِ أَشباهٌ عَوادينا نَشْجى لِواديكَ أَم نَأسَى لِوادينا
ماذا تَقُصُّ عَلَيْنا غَيْرَ أَنَّ يَدًا قَصَّتْ جَناحَكَ جالَتْ في حَواشينا
رَمى بِنا البَينُ أَيْكًا غَيرَ سامِرِنا أَخا الغَريبِ وَظِلًّا غَيْرَ نادينا
كُلٌّ رَمَتهُ النَوى، ريشَ الفِراقُ لَنا سَهْمًا، وَسُلَّ عَلَيْكَ البَينُ سِكّينا
إِذا دَعا الشَّوْقُ لَمْ نَبْرَحْ بِمُنْصَدِعٍ مِنَ الجَناحَينِ عَيٍّ لا يُلَبّينا
فَإِن يَكُ الجِنسُ يا اِبنَ الطَلحِ فَرقنَا إِنَّ المَصائِبَ يَجْمَعنَ المُصابينا
لَم تَألُ ماءَكَ تَحْنانًا وَلا ظَمَا وَلا اِدِّكارًا وَلا شَجْوا أَفانينا
تَجُرُّ مِنْ فَنَنٍ ذبْلًا إِلَى فَنَنٍ وَتَسْحَبُ الذَيلَ تَرْتادُ المُؤاسينا
أُساةُ جِسْمِكَ شَتَّى حينَ تَطْلُبُهُم فَمَن لِروحِكَ بِالنُطسِ المُداوينا
والشاعر في هذه الأبيات حيران، يجعل الطائر في حالين: حال المغترب وحال المقيم، فما تدري أيبكي من الغربة أم ينوح من فقد الأليف، ومع حيرة الشاعر وضلاله عن تحديد ما يريد نراه بلغ غاية الرفق حين قال:
تَجُرُّ مِنْ فَنَنٍ ذبْلًا إِلَى فَنَنٍ وَتَسْحَبُ الذَيلَ تَرْتادُ المُؤاسينا
وهي حال تشهدها في الطائر المحزون، فقد نرى الطائر يتنقل على غير هُدى من أيْك إلى أيْك، فنعرف أنه يبحث عمن يواسيه، ولكن أين من يواسي الطائر الحزين؟ إن شوقي نفسه أخطأ حين قال:
أُساةُ جِسْمِكَ شَتَّى حينَ تَطْلُبُهُم فَمَن لِروحِكَ بِالنُطسِ المُداوينا
فإن الطائر لا يجد من يأسو جسمه، وإنما يجد من يذبحه ويشويه، والناس ألأم من أن يطبُّوا لطائر جريح!
وانتقل ابن زيدون من شكوى البين والأعداء والزمان إلى معاتبة حبيبته، فذكر أنه لم يستمع وشاية ولم يعتقد إلا الوفاء، أما شوقي فقد انتقل من خطاب الطائر إلى بكاء الأندلس والحنين إلى مصر، فقال:
وَاها لَنا نازِحَي أَيْكٍ بِأَندَلُسٍ وَإِن حَلَلْنا رَفيقًا مِن رَوابينا
رَسْمٌ وَقَفْنا عَلى رَسْمِ الوَفاءِ لَهُ نَجيشُ بِالدَمْعِ وَالإِجْلالِ يَثنينا
لِفِتيَةٍ لا تَنالُ الأَرْضُ أَدْمُعَهُم وَلا مَفَارِقَهُم إِلّا مُصَلِّينا
لَوْ لَم يَسودوا بِدينٍ فيهِ مَنْبَهَةٌ لِلناسِ كانَتْ لَهُمْ أَخلاقُهُم دينا
لَم نَسْرِ مِن حَرَمٍ إِلّا إِلى حَرَمٍ كَالخَمرِ مِن بابِلٍ سارَت لِدارينا
لَمّا نَبا الخُلدُ نابَت عَنْهُ نُسْخَتُهُ تَمَاثُلَ الوَرْدِ خِيرِيًّا وَنَسْرينا
نَسْقي ثَراهُم ثَناءً كُلَّما نُثِرَت دُموعُنا نُظِمَت مِنْها مَرَاثينا
كادَت عُيونُ قَوافِينا تُحَرِّكُهُ وَكِدنَ يوقِظنَ في التُربِ السَلاطينا
وللقارئ أن يتأمل الحسن في هذه الأبيات، فالشاعر يغلبه الدمع، وهو يتذكر ملوك الأندلس، ولكن الإجلال يثنيه عن البكاء؛ لأنه في ديار قوم لم تنل الأرض أدمعهم ومفارقهم إلا عند السجود، فهم لم يعرفوا الخشوع لغير الله، وذلك من أبعد الغايات في الثناء.
ويأبى أحمد شوقي إلا أن يحرص على المعاني الشعرية، فهو في الأندلس لا يسري من حرم إلا إلى حرم، ولكن كيف؟ كالخمر سارت من بابل إلى دارين! وقدسية الخمر لا تجوز في غير مذاهب الشعراء.
ثم قال في الحنين إلى وطن النيل:
لَكِنَّ مِصْرَ وَإِن أَغْضَت عَلَى مِقَةٍ عَيْنٌ مِنَ الخُلْدِ بِالكافورِ تَسْقينا
عَلى جَوانِبِها رَفَّت تَمائِمُنا وَحَوْلَ حافاتِها قامَتْ رَواقينا
وهذا معنى قديم سبقه إليه من قال:
أحَبُ بِلادِ الله ما بَيْنَ مِنْعِجٍ إليَّ وسَلْمى لَو يَصوبُ سَحَابُها
بِلادٌ بَها نِيطَتْ عَليَّ تَمائمي وأوَّلُ أرْضٍ مَسَّ جِسْمي تُرابُها
والبِكْر هو قول شوقي:
مَلاعِبٌ مَرَحَتْ فيها مَآرِبُنا وَأَربُعٌ أَنِسَت فيها أَمانينا
وإنما كان هذا معنى بكرًا لما فيه من طرافة الخيال، أرأيتم كيف تمرح المآرب، وكيف تأنس الأماني؟
لقد رأيت شوقي أول ما رأيته سنة ١٩٢١م، وكان دعاني للغداء عنده بالمطرية مع الأصدقاء الأكرمين مصطفى القشاشي، وسعيد عبده، وأحمد علام، فعجبت يومئذ لذلك المبْسم الساحر، وسألت نفسي: كيف كان ذلك الملاك في صِباه!
إن حنين شوقي إلى مصر حنين عميق؛ وإنما كان كذلك لأن الشاعر شهد في مصر دنيا من الحب والمجد لم يظفر بها إلا الأقلون، ودنيا شوقي لم تكن مثل دنيا الناس في هذا الزمان، كانت الدنيا في شباب شوقي تفيض بالبشر والإيناس، وكان الشاعر يعيش فيها عيشة مُضمخَةً بالسحر والفتون، وكان للجمال قدسيةُ، وكان للصبا سُلطان، وكانت خطوب الزمان لا تهد النفوس كما تفعل هذه الأيام.
الهوامش:
1 – هو أبو القاسم الحسن بن بِشر بن يحي الآمِدي، ولد بالبصرة ونشأ فيها، واختلف المؤرخون في تحديد تاريخ وفاته وحدَّدوه بين سنتي (370هـ-371هـ)، عُرف بسعة علمه، ودقة معرفته بالشعر والأدب والنحو، من
مؤلفاته: المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام وشعر البحتري، وكتاب نثر المنظوم، كتاب ما في عيار الشعر لابن طباطبا من الخطأ، كتاب فرق ما بين الخاص والمشترك.
2 – سعد إسماعيل شلبي: مقدمة القصيدة عند أبي تمام والمتنبي، مكتبة غريب، مصر، (د.ت)، ص 13.