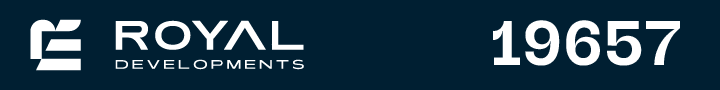أتذكر أنا وأمثالي العام 1936 جيدا، ليس لأنه العام الذي افتتح فيه رجل قصير القامة يدعى أدولف هتلر دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لإظهار “وجه برلين القوى والفتي والشاب في حدث اجتمع من أجله نحو 4 آلاف لاعب ولاعبة من 49 دولة”.
أتذكره فقط لأنها السنة التي خرجت أمنا الأولى للوجود، كأول لفافة تبغ في العالم ينتهي جسدها بفلتر من الفلين.
بعد 80 عاما تواطأت عدد من الماكينات لأكون أنا استمرار لتلك الجدة العزيزة: أنا علبة فايسروي حمراء منبعجة ومضغوطة قرب رصيف مترب في شارع جانبي من شوارع غرب الإسكندرية.
سيطرح البعض: وهل لعلبة حمراء استهلكت سجائرها ونفدت، وداستها الأقدام وإطارات السيارات المطاطية -على اختلاف نوعياتها؛ تكاتك مشاريع (ميكروباصات) تُمنيات (سوزوكي)- أن تحتفظ بذكريات عائلية تضرب بجذورها في التاريخ النازي، وتشير إلى أصلها الوراثي الكرتوني في سلسال العائلة التبغية.
سأجيب: علينا أن نتفق أن هذا ما جرى رغم ما يحمله من جنون ولا معقولية. علينا الاتفاق كذلك أنني ورغم وضعي البائس والمتضعضع والمدهوس أقرأ الأفكار، لهذا لن أرد عليكم؛ لست مزودة بحنجرة وفك علوي وسفلي ولسان لإنتاج الكلام، لكن رجلا مسنا قطع الطريق أمامي قبل ربع دقيقة من الآن يرى أن الحقائق في هذا العالم خاضعة لسطوة الاحتمالات، تتقطر الأفكار والذكريات من دماغه وتتناثر من شعيراته إلى أسفل، إلى حيث استقبلها أنا. معلومات عن عمله السابق -قبل التقاعد- كرئيس قسم الفيزياء النووية بإحدى الجامعات الروسية. أنا واحدة من تلك الاحتمالات. لما لا تتحدث علبة سجائر حمراء؟ تسألون. لماذا لا؟ أجيبكم ولدي من تفاصيل الكون نفسه ما يعزز أطروحتي.
في الشارع الذي اندس بأوحاله الجافة تقع أرض مسورة حددتها جهة ما بـ”أرض الإصلاح الزراعي” ترتفع من داخلها رؤوس أشجار وزريعات. لا تسعفني قدمي -لأنني لا أملك مثلهما- على المشي وتسلق السور متوسط الارتفاع كي أعرف ماذا يحدث بداخلها، رغم هذا أتسند، أتشجع أملة في الذهاب إلى هناك، معتمدة على قصة حكاها أحد الصبية لشريكه في اللعب عن السندباد البحري، أرى الفضول يلتهم أكبادكم: من أين لك بالقدرة على تحديد الأعمار، قد أهرول بالإجابة: الصغار غالبا ما يكونوا أقرب إلى الأرض، وأقل طولا من البالغين، لكنني لن أضيع وقتي القصير؛ فقد يكنسني عمال شركة من شركات النظافة والتجميل بعد قليل ويكون مستقرى النهائي بين فكي فرامة سيارة قمامة تعيدني إلى مبدأي كمواد خام . ورق. بلاستيك. حبر مطبوع.
أتسند على الحكاية الشهرزادية، امتلأ عبر استرجاعها بالأمل في إمكانية -أليس الكون غابة احتمالات- رؤية أرض الإصلاح الزراعي بل والعيش هناك؛ يقول الصغير لصديقه متلهين بالقصة في مسيرتهما لشراء “فول سايب” و”فلافل” لعائلتيهما:
يصل السندباد البحري إلى جزيرة مجهولة. يتوسل إليه شيخ ضئيل الهيئة أن يحمله على أكتافه مدعياً الوهن، يحمله السندباد لكن الشيخ يرفض النزول، صنع الرجل الذي تبين للسندباد لاحقا أنه عفريت من عظام الأخير عرشا لن يفارقه إلا بالموت.
السندباد في حيرة، أعمار العفاريت مديدة، قد تستغرق مئات أو آلاف السنوات، سيتخلص منه الراكب المتسلق في أول إغماءة احتضار، سيفارق رمته الأخذة في التشكل كهيكل عظمي، ويكمن أمام الشاطئ مدعيا التهالك والإنهاك إيقاعا بضحيته الجديدة. يلجأ السندباد -ولم يكن بالذكي لكن الأيام علمته الحنكة وإيجاد المخارج من المآزق بفضل تدفق إدرينالين الأخطار وغريزة حب البقاء- إلى التلافيف الرمادية المكبسة داخل جمجمته، يغمز مخه ملقيا إليه بحبل نجاة: الخمر يا سندوبي الخمر.
يشرب العفريت ما تصنع أيدي الفتى من الأعناب الموجودة بكثرة شرقي الجزيرة، حين يغيب عن الوعي يقتله الطفل الذي أنت عظامه من حمل هذا المسخ. يجمع السندباد بعض ثمار جوز الهند -لا أعرف لماذا.. أنا مجرد علبة من الورق أحمل صورة شخص مريض بسرطان الرقبة- ويعود بمركبة إلى البصرة. ينتهي الفتيان، واحد من القص والثاني من الاستماع، في ذراعيهما اليمنيين كيسان شفافان بداخلهما يستقر آخران يحفظان الفول المحلى بسلطة الخضراوات والطرشي.
هل يلتقطني عابر للدرب، هل يسقطني أحدهم في الأرض الزراعية المسورة المهجورة، لأعيش دهرا ما بمبعدة من فرامة القمامة؟ أنا مستعدة للعب دور الشيخ الجني لكنني لن أستغل أي كتف سندبادي، لن أحول معاناة البشر إلى مقاعد وعروش أبدية، سأكتفي بعدة دقائق محدودة تسمح بنقلي عبر يد شاب أو امرأة إلى فردوسي المرتجى. لا أطلب المحال. فقط انزعني من بين الدنس والأتربة. احملني إلى الأخضر متنوع الخضرة.
يمر رجلان، تخطيا السبعين من عمريهما. يقفان قربي، متلفتين بين آن وآن إلى حركة الشارع، يحاذران من سائق أعمى أو متعام، لا يضع في حساباته أبعاد المسافات، يرغبان في امتلاك مزيد من السنوات، يستعينان لأجل ذلك باليقظة والانتباه. يجاوران الرصيف الآمن الذي أغفو وأصحو على مرأى ومسمع من أحجاره المصطفة في نظام لا يخلو من النقر والتشوهات. الأول يعتمر طاقية والثاني يمسك علبة “إل إم” زرقاء جديدة، اشتراها لتوه من سوبر ماركت قريب. اه لو كانت قديمة خاوية تستقر هنا جواري وتؤنس أيامي الناشفة الغليظة.
الدنيا من غير ناس متنداس. يصرح معتمر الطاقية ومن تحت دماغه تي شيرت يقابل القميص ذو الكمين القصيرين لدى صنوه.
أتحسر أنا متفكرة في العبارة. ولا تفارق عيني “الإل إم”. جدتها الأولى أصغر من جدتي. تم أنتاجها عام 1952 أو 1953، إن لم تخني الذاكرة. أتلهى عن المتحدثين من فرط غزارة الاستدعاءات الذهنية.
يخالف موتوسيكل سريع التوقعات، يصعد إلى الرصيف ويرتحل أحد الشيخين إلى عالم هاديس -وهو بالمناسبة إله الموت عند الإغريق- قبل قول الشهادتين، بعد أن تصنع منه الدراجة البخارية كرة بينج بونج متطايرة للحظات قبل تسديدها في مرمى الفناء. تستقر الزرقاء بجانبي وقد تلونت ببعض الأحمر اللازج، دماء القتيل المرتمي.
هي الآن اثنان في واحد. تحقق حلمي بمأساة. تمهلنا يومين كي نبدأ أحاديث السمر بيني وبينها. الفاجعة شلت ألسنه لفافاتها لفترة.
متمتعان بحظ وافر يحجب أعين عربة النظافة عنا نتخذ شعارا أنا وهي: هناك مكان محجوز بالجحيم لكل شخص يصعد بـ”فيزبته” إلى الرصيف.
ننسب المقولة المختلقة إلى دانتي كي تكتسب متانة من الزيف. أخبر زميلتي في اليوم الأخير قبل “الفرم” -وهو مصيرنا كلنا شئنا أم أبينا- عن سيرتي الذاتية ومولد الأم الأولى مع احتفالات النازيين الحمقى بالأولمبياد.
أحكي لها وكف عامل النظافة ذي الرداء المميز والأيقونة المرتسمة فوق قماش زيه تلقيني داخل المجهول: أتعلمين يا ليما -تدليل للإل إم- أتعلمين يا زرقاء العيون، لم يكن نجم الدورة الأولمبية ألمانياً -على العكس مما أمله هتلر- إنما الأمريكي الأسود جيسي أوينز، حصل القادم من بلاد اليانكي على 4 ذهبيات.
عندما هزم الأمريكي أوينز الألماني لوتس لونج في مسابقة القفز الطويل بالذات، غادر هتلر الاستاد غاضبا… وداعا أو إلى لقاء.