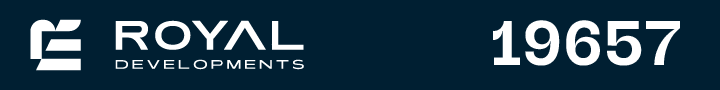كان اليوم الأخير في حياة الفنانة سلوى نصار عجيبا. تابعتها وأنا صغيرا من خلال 14 حلقة من مسلسل البشاير الذي يبدأ تتره بصورة حمامة تحنو على أخرى.
شكلت تلك الموسيقى يدين سماويتين ترفع أعمارنا لأعلى وتشتتها بالعدم فكأننا لم نكبر. في نوفمبر الجاري فقط أدركت أن مؤلفها الموسيقار محمد سلطان، هو ما أدركته يوم وفاته مع إلحاق صحفي ما سيرته الذاتيه وأعماله الفنية في ذيل التقرير الإخباري عن الفقيد.
شكلت “البشاير” شيئا روحانيا لي أنا ابن أوائل الثمانينيات. القصة عن نجمة سينمائية -قامت بدورها مديحة كامل- تهرب من لوكيشن التصوير في الصحراء، تنقلب عربتها في ترعة بقرية الدلجمون-بحثت عنها الكترونيا وعلمت أنها تقع شمال الدلتا- ينقذها أبو المعاطي أو كما يعرفه الناس الجالسين أمام الشاشة بمحمود عبد العزيز، ينقذها بعد أن أو لأنه المتسبب في إسقاطها. حين تستفيق تبدأ رحلة تعرف على المزارعين البسطاء ورحلة ثانية تتعافى فيها من نشقات الهيروين.
كان اليوم أو للدقة المشهد الأخير للفنانة سلوى نصار مختلفا. حين شفطتني الشاشة الصغيرة وعثرت على ذاتي داخل الحلقة الأخيرة من المسلسل وبت أحد أبطاله بفعل سحر أُلقي علي من طرف لا أعلمه، كانت سلوى أمامي، تستند إلى المائدة التي يستند إليها كذلك المخرج هشام -عبد العزيز مخيون- والمنتج رشاد الفوال – محمد التاجي- صاحب اللازمة الشهيرة “عصبي اوي ياسعيد” وسعيد -الفنان عادل أمين..الله يرحمه-.
كنت على دراية أن بعض من هؤلاء -الفنانون لا الأبطال- ماتوا منذ آماد مديدة، أبناء عوالم أمام الشاشة يعرفون أن مديحة كامل ومحمود عبد العزيز وأمينة رزق والذين كان لهم الفضل الأول والأخير في ترك أشباههم داخل الحلقات، ماتوا منذ سنوات، على فترات متقطعة وليس في وقت واحد، لكن داخل التلفاز داخل المسلسل يختلف الوضع، هنا الخلود عملة لا تبلى، ومهما مرت قرون أو نشأت أعاصير وزلازل وأوبئة لن تموت الشخصيات.
شعرت بحنين إلى عائلتي، يجلسون أمام جهاز العرض متعجبين كيف قفز ابنهم -أنا- للداخل وصرت خالدا كالباقين هناك. في تحير تنازعتني رغبتان؛ أن أظل وأن أعود. طالت حيرتي وامتدت، نظرت سلوى إلى مستفهمة عن من أكون، لوحت لي فذهبت وجالستها لساعة حاكيا لها -لم أستطع الكتمان- كيف ماتت أمها التي أنجبتها عبر الكاميرا “ماتت مديحة كامل على سجادة الصلاة” ..حزنت لكنها لم يقتلها الحزن، الحقيقة أنها ظنتني مجنونا اتحدث عن أكوان غريبة عجيبة ومصطنعة؛ “من مديحة ومن فلان وعلان!!!” فكرت هي خلال تأملها لي، تركتني على وعد باللقاء، ربما راقها “جنوني هذا الذي تحدثت عنه وأرادت المزيد من أساطيري عن العالم الثاني ذاك”، انصرفت مغادرة للقيام بالمشهد الأخير في المسلسل، حيث تعيد زيارة العائلة القروية ويهبط التتر خاتما كل شئ.
حين عدت، اقتطعت يد حمقاء كل مشاهدي واعتبرتها مقحمة . لم تعترف اليد بقدرة الساحر الذي رماني هناك، اشتقت لجلستي مع سلوي وعصير البرتقال بطعم الثمانينات الذي لم أذق مثله منذ طفولتي إلا حين طالعت جمال أنفها وعينيها وكلها. كانت سلوى ربة حسن هندية لن تتكرر.
حين عدت أيضا لفت شقيقي الأكبر – وهو من عشاق نفس المسلسل- انتباهي لشئ غريب، رأى هو أنه لم يشاهده في العمل من قبل: تحكي سلوى نصار عن صديق غريب الأطوار ومسلي التقته في مطعم. ترفع كفها اليمنى فيتبدى حول بنصرها خاتم. أطالع المشهد وأتيقن أنني بالفعل كنت هناك.
هذا الخاتم أهديته لها في لقائنا الوحيد. هذا الصديق الغريب المحكي عنه هو (جنابي). أشرت إلى نفسي ولوح زجاجي يفصل بيني وبين البطلة. أناديها “أنا هنا” لكنها لا تجيب؛ لا هي ولا مديحة
تنويه غير مهم
المسلسل متوفر على موقع اليوتيوب لكنك لن ترى الخاتم أو تسمع عني من لسان سلوى في مشهدها الأخير. يبدو أن المخرج عاد واقتطع كل ذكر لي. لست مستاء أبدا.
اقرأ أيضًا : محمد عطية يكتب : مدرسة نعناعة!!