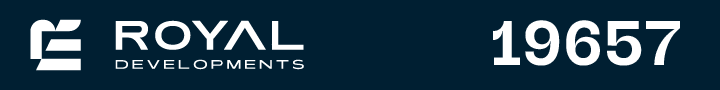مات العالم، لكنه لم يُدفَن بعد.. ذات خريفٍ سام ومُهلك، أفرجتْ السماء عن بعض دموعها، لتكشف عن جذام المدينة العتيقة.
حجارة الرصيف الزلقة، والحذاء العالق في الوحل، والدموع التي تتلمس الطريق.
بائعات الهوى شيطاناتٌ جشعات، يلتصقن بك كالقشريات البحرية وينهشنك كالنمل. نساء بنهودٍ طريّة كالهُلام، لا يفسحن لك المجال للمساومة في هذا الوقت من المساء، فالنقود التي تنضح بالعرق البشري تنتشر كحريق في غابة النساء. مع نساء المتعة، يجب أن تُعالَج الأمور ببطء، ولا بأس من إمطارهن بالثناء وكثيرٍ من الملاطفة.
والزبون يبتسم مثل بقّةٍ نالت كفايتها. لا يفكر إلا في مضاجعة محظيةٍ وترطيب ملتقى فخذيها، قبل أن يستلقي فوق بطنها مثل جروٍ صغير. قد يتذوق الشفة المرضوضة كحركةٍ ختامية، وقد تسليه قليلًا بأن تحكي له -بعينين مثقلتين بالنعاس- نبذةً عن عثراتِ حظها مع الرجال، وتُبقيه مجرد مستمعٍ بلا أوهى شرارةٍ من عاطفة.
مقدمو البرامج يوزعون ابتسامات سامة، حتى تكاد قِطعٌ من الفك تتساقط على الهواء. خلف كلماتهم يكمن عبثٌ طاغٍ. والضيوف المتأنقون يبدون للمشاهدين مثل عملةٍ مزيفة.
والمُعارِض يكرر مواقفه البلاستيكية بتوكيدٍ أقرب إلى عودة مهووسِ الاضطهاد إلى هاجسه.
عامل التوصيل بلا خوذة في طريقٍ لا تسلكه الملائكة، وهو يضغط على دراجته النارية بقدمين مدفونتين في جوربيه الممزقين.
واللص الذي يسرق الحقائب والبنوك، يعبر الطريق هاربًا باتجاه حافلة معطّلة.
نزلاء الغرف الضيقة يتمددون بتلك السِحَن القلقة، وأقفاص العصافير مُعلَّقة في النوافذ، وهي تزقزق بجنون.
في بقعةٍ أخرى، تحدث المعجزة، ويبقى فقراء على قيد الحياة، برغم هَم الفواتير وغم الإيجار المتأخر. يكدحون باكرًا في شوارع تشبه في مظهرها فمًا يتثاءب، بغض النظر عن الكوارث، والجرائم، وحوادث السير ، وعجز الجميع عن إيقاف تدفق الموت المجاني.
الأيام تتعاقب، بلا ماضٍ ولا مستقبل. وأدوية الضغط المرتفع هي الأكثر رواجًا.
يقال إن المدينة لا تُظهِر روعتها المشؤومة إلا بعد أن يرتدّ ضوء النهار منسحبًا، وهذا صحيحٌ إلى حدٍ كبير.
هذه المدينة تبتسم لأهلها بألم، ابتسامة واهنة تستعصي على الوصف..
ولا فائدة من إحاطة مشهد النهاية بشيء من الجلال!