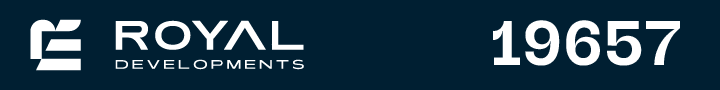نادرا ما تنجح بعض الروايات في إزاحة صدأ الأيام والسنوات عن ذاكرتنا وتعيدنا إلى أزمنة براقة خلابة ظنناها ضاعت وتاهت تحت وطأة العمر وجريانه.
إحدى تلك الروايات هي “الحرب في الشرق” تأليف الدكتور زين عبد الهادي والتي بمجرد أن تبدأ في قرائتها حتى تعاودك صور قديمة من الماضي البعيد، بالأخص من بورسعيد. مسقط رأس والدي.
لم أزر بورسعيد إلا مرات قلائل في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، لكن الرواية أعادت إلى تفاصيل غفيرة وكثيرة حسبت أنني نسيتها عن هذا المكان الفريد مثل شوارع التجاري والثلاثيني وكسرى والأمين وحلوى السمنية والشكلامه التي تعد من علامات المكان ورموزه التراثية مثلها مثل قاعدة ديلسبس وممشاه وطيور النورس والمعدية والفنار.
مع شخصيات العمل تجد نفسك تدمج مقاطع الأغاني. تشارك في لعبة الموسيقى المركبة، أو كما فعلت إحدى بطلاته “كانت تغني مقطعا من هنا ومقطعا من هناك في تداخل لحني فريد لم تصنعه أي مطربة من قبل”
أنارت لي الصفحات أراض معتمة في عقلي. سلطت عليها مصباحا وجعلتها متجلية وضاءة. من بينها حالة الوجد والعشق الخاص الذي يكنه البورسعيدية لعبد الناصر وأيامه. مصانع الغزل والنسيج. الأباء والأمهات الذين يبدعون فنونهم من غناء ورسم وكتابة القصص القصيرة في الخفاء. كأنهم رهبان لا يرجون مقابلا ماديا أو معنويا، شهرة أو مجد. فقط يتمتعون بما يفعلون. وإن ننسى لا ننسى الطبلية التي جمعت أبائنا وأجدادنا قديما في صباحات وأمسيات السمر والتواد العائلي. حين كان الحب والسعادة عضوين بالأسرة.
في دنيا “الحرب في الشرق” ستجد هذا الذي يهبط على البشر في تلك المحافظة -البعيدة مسافاتيا، القريبة روحيا من قلوبنا- ليغني للناس ويهبهم الفرح والبهجة. ستتفاجأ بالأفلام وأسطوانات الموسيقى التي تصل هذا البلد الجميل في نفس أسبوع إصدارها بأمريكا وأوروبا. مع توالي القراءة وجدت نفسي أنشد من تراث القنال “عالسمسمية إسمع يا سيدي..ألحان شجية من البورسعيدي ..غني يا حمام ..كمان وكمان وكمان وكمان”.
وفي هذا استطاع النص البديع أن يعيد لي جزءا من الروح توارى ليعود. ألا وهو الأصل الذي لا يغيب مهما فعلت الشهور والقرون وفعلنا.
أجد نفسي مثل ساكني الأكواخ في الرواية والذين تبقوا بعد حفر قناة السويس وتركهم الخديوي إسماعيل، أحلم مثلهم ليس بالثراء، وإنما بعدم ضياع شئ من ماضينا وتاريخنا وذكرياتنا وهويتنا. أجدني أردد مع الرواي بطل العمل “الحياة لا تكتمل أبدأ بأي شكل، لا بد أن تترك خلفك شيئا لم يكتمل أبدا ولن يكتمل”.
أجدني أكتب معه أسماء كل من عرفت على الباب الخشبي مستخدما مسمارا لتدوين حياتنا نحن أبناء الشمال، وأتابع رقص الدلافين في قناة السويس، بينما تنقلني المعدية بين ضفتين.