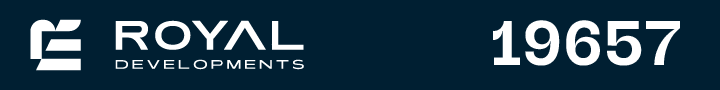يخبرني صديقي وزميلي السابق الذي لم أره منذ 30 عاما، ربما منذ حرب الخليج الثانية أنه عثر على السعادة أخيرا بعد رحلات اتسمت بالمشاق والصعاب في ربوع الولايات المتحدة وبلاد الصقيع الكندي وزيارات أخرى أقل زمنا في الهند ومنغوليا والصين.
قال لي في رسالته التي وصلتني عبر البريد الألكتروني أنه لم يجد سعادته في الأسفار وإنما في التذكر حين عاد إلى أرض الوطن سالما وشم رائحة الطلاء القديم -أو تخيل أنه فعل- على جلد الباب الخشبي لبيت العائلة الكبير في فارسكور بدمياط. نفس البيت الذي استضافتني عائلته به العام 1975 مع زيارة السادات لمسقط رأسه بميت أبو الكوم. لا أجد أي رابط -إلا الصدفة- بين الزيارتين.
صديقي (ج. ر.ن) والمعروف بخفة ظله في الأوساط الإعلامية والأدبية الإقليمية يؤكد لي عبر خطابه: “لا تصدق نصف ما تسمع وربع ما ترى. الضحكات التي تنطلق مجلجة في المؤتمرات والفعاليات والتجمعات الدولية مصطنعة، هي للاستهلاك المحلي أو العالمي، الغرض الوحيد منها عدم إخجال الأخر الذي نخاطبه (مش هينفع نقوله دمك ثقيل)”
تردد في داخلي صوته ورنة من حزن وفرح ممتزجين بداخله وأنا استكمل مطالعة الرسالة:
“شربت كوبا من عصير القصب في شارع المعز وسجلت اسم المحل وإحداثياته داخل هاتفي لأنني سأعود إليه كلما فاض بي الحنين إلى السعادة، لم أذق ما هو أطعم منه في مكان ما.
تبادلت حديثا لا هو بالطويل ولا بالقصير مع بائعة مناديل في أحد ميادين الدقي، كنت قد التقيتها قبل عقود، وكانت وقتها غادة حسناء في بدايات مهنتها المتوارثة عائليا، تذكرتني حين أخبرتها أنني عابر السبيل الذي كان يسألها عام 1992 عن شارع يقع به مقر جريدة عربية بدأت العمل لديها كمراسل، نطقت هي اسم الجريدة بالخطأ، وظللت شهورا أمر يوميا بجوار الرصيف في ميدان المساحة حيث معهد جوتة للغة الألمانية، ابتاع منها كيس مناديل وأتقاسم معها نكتة جديدة عن خطأها في نطق الاسم.
في لقائي الأخير معها قبل أسبوع والذيةجاء بعد غياب سنوات ختمت كلامها بما أقلق منامي (الله يرحمها أيام يا حج) . حج؟..لم أذهب إليها بعد هذا التوصيف العمري لشخص -هو أنا- يرى ذاته ولو بالخيال لا زال مراهقا في السادسة عشر من مرة وربما أقل من ذلك بعشرة سنوات”.
نصحني صديقي عبر الرسالة الألكترونية -ولم أكن بحاجة إلى نصائحه فأنا لا أريد لا سعادة ولا دياولوه. لا أريد إلا راحة البال- أن أشاهد المسرحيات القديمة لفؤاد المهندس وأفلام عادل إمام بين عام 80 و90 .
ود لو اجتمعنا سويا -ولو مرة أخيرة قبل عودته للمهجر- على مقهى التكعيبة وننشد معا كما كنا نصنع في أواخر السبعينات -غير مبالين بالانتفاضات ضد السادات- ما يلذ لنا من الفيروزيات والورديات والشاديويات والنجاتيات والحليميات. لكنني رفضت، لا عن كراهة أو عداء للماضي لا سمح الله، وإنما لما أصاب جسدي من وهن الأيام وما شهده من إفراغ الملل له من كل مسببات البهجة.
لا أريد إلا وجباتي الثلاث كل يوم وانتهاء فصل الصيف والخوف من الشتاء حيث توغل حساسية الأنف في خنق أنفاس الرئتين وتشتد الحكة في منطقتي الإبطين بلا داع طبي وتفترش الإكزيما بملائتها المبقعة على سطح قدمي. تعللت بالمشاغل واعتذرت عن طلبه. سافر هو مجددا إلى سان فرنسيسكو حيث يقيم مع عائلته مذ هاجر.
وبعث إلى بإيميل جديد يخبرني فيه أنه اشترى قبل السفر كميات من عجين الطعمية وشرائط كاسيت لإيهاب توفيق وحميد الشاعري وعلاء عبد الخالق ومصطفى قمر وعمرو دياب ومدحت صالح ومحمد الحلو، قال بالحرف الواحد لي: حان الوقت كي نجرب الاستماع إلى الأجيال الجديدة. كان هذا في يناير قبل الماضي -2021- قرأت ما أرسله. وارتفعت زاوية فمي اليسرى ربما استهزاء ربما شفقة عليه. ربما كرها له.
ربما كل هذا وذاك. أغلقت اللابتوب وغفوت في نومات بلا أحلام. كما هي حياتي منذ سنة 80. عام التخلي عن كل الأحلام وتوديع الحياة الجامعية والغطس في سنوات العمل والمحن.