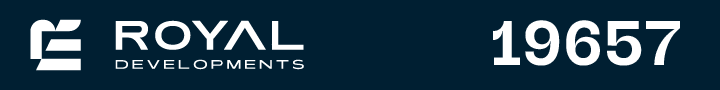“سينما المؤلف” من أكثر المصطلحات السينمائية التباسا لدى العرب كلهم، وليس في مصر فقط، فالكثيرون يظنون أنه يعني ببساطة أن يكتب المخرج فيلمه، وهذا – في الحقيقة – ليس له علاقة بجوهر المصطلح الذي صار منذ عقود اتجاها نظريا وعمليا في عالم الفن السابع.
قد يكتب المخرج جميع أفلامه ويظل أبعد ما يكون عما كان يقصده النقاد الفرنسيون حين صكوا هذا المصطلح في منتصف خمسينات القرن الماضي ليشيروا إلى السينما التي يصنعها المخرجون للتعبير عن ذواتهم ومعتقداتهم ورؤيتهم الشخصية للفن والحياة، والأهم: تنفيذ المخرجين مشروعاتهم السينمائية الفكرية الخاصة التي قد لا يكفي فيلم واحد أو اثنان لبنائها وإتمامها.. ولأن الأفلام من المفترض أن تحمل – في ظل هذا المفهوم – رؤية ذاتية / شخصية / خاصة، يتولى المخرجون كتابتها إن كانوا يجيدون ذلك، حيث يصعب أن يجدوا كتاب سيناريو يشاركونهم إياها ويضعون معهم اللبنة فوق الأخرى لبناء مشروعات هم وحدهم الذين يعرفون فلسفتها وأبعادها وأهدافها.
ولا شك أن المخرج داود عبد السيد من القليلين الذين ينتمي شغلهم إلى سينما المؤلف في عالمنا العربي، عبر رؤية خاصة جدا للحياة والفن كما أسلفت، ومشروع فكري بصري واضح المعالم من الممكن أن يتلخص في كلمة واحدة: “الحرية”، بكل ما يتعلق بها ويتفرع منها من تحد للعجز، وتحطيم للقيود، وانعتاق، وتحليق، وانفتاح، وقبول للآخر، وكسر للتابوهات والرتابة والثوابت المقيتة.
وأكبر دليل على أن سينما المؤلف لا تعني “فقط” أن يكتب المخرج السيناريو، أن داود حافظ على نفس المشروع في الفيلم الوحيد الذي لم يكتب له السيناريو والحوار، وهو “أرض الأحلام” (1993)، من تأليف هاني فوزي، حيث يتابع امرأة في رحلتها للحصول على حريتها والتمرد على حياتها الرتيبة المغلقة والتخلص من الضغوط التي يمارسها أبناؤها عليها بسلطة البنوة لكي تسافر إلى الولايات المتحدة وتساعدهم في الهجرة.. كما حافظ على مشروعه في الفيلمين اللذين كتب لهما السيناريو والحوار عن قصص لغيره، وهما “الكيت كات” (1991)، عن رواية “مالك الحزين” لإبراهيم أصلان، و”سارق الفرح” (1995)، عن قصة قصيرة لخيري شلبي بنفس العنوان. ويمكن القول، بطريقة أخرى، أنه اختار من قصص غيره ما يخدم مشروعه.
بشكل عام، ينشغل المؤلف داود بالإنسان، وحيرته مع أسئلته الوجودية، وينتصر لحريته، ليس فقط بالأفكار المجردة، ولكن أيضا بدعوته دائما ومباشرةً لأن يتذكر أنه حر، ولأن يحترم جانبه المرهف الذي يصنع الفارق بينه وبين الحيوان، ولأن يحب الآخرين ويحاول أن يفهمهم وليس أن يدينهم، وألا يتعدى حدود القانون في التعامل معهم، والأهم أن يرفض – في كل الأحوال – بيع نفسه.
وهناك دائما ما بعد / وراء الصورة في كتاباته / أفلامه.. هناك الميتافيزيقي، السحري، الفلسفي، أو سمه ما شئت، الذي ينقلك إلى عوالم أخرى قد لا تكون ملتصقة بالأرض التي تعيش عليها أو حتى بالقصة التي تتابعها، لكنه يأخذ بيدك لتلم بكل أعماقها وبكل مستويات تلقيها، ويحلق بك في سماء ترى منها أفضل، وتغسل فيها ما علق بروحك من شوائب.
بدأ في منتصف الثمانينات – شأن كثيرين من أبناء جيله – بتصفية حساب الطبقة الوسطى، خاصة أبنائها من المثقفين المثاليين، مع الانفتاح الاقتصادي وحيتانه وقططه السمان في فيلم “الصعاليك” عام 1985، من خلال قصة “مرسي” و”صلاح” اللذين يصعدان من القاع إلى القمة باستخدام كل آفات وموبقات الفساد واللصوصية والهرم الاجتماعي المقلوب.. ثم غاب ست سنوات وعاد ليضع، في “الكيت كات”، اللبنة الأولى لمشروعه الخاص، الذي استمر يبني فيه حتى فيلمه الأخير – حتى الآن – “قدرات غير عادية” (2015).
يثبت “الكيت كات” أن داود سيناريست شاطر وصاحب شخصية ورؤية، فلم يسخره فقط لخدمة مشروعه القائم على الانعتاق من القيود واقتناص الحرية، من خلال الكفيف الذي يتحدى عجزه وينتصر عليه، إلى درجة أنه يقود موتوسيكل، بل قدم فيه واحدة من أفضل المعالجات السينمائية للروايات الأدبية في تاريخ السينما المصرية، حيث حافظ على روح وسحر الرواية الأصلية مع تأليف “رواية سينمائية” موازية تصلح لرؤيته وما يريد التعبير عنه.
فقد نقل بطولة الأحداث ومحورها من الشاب “يوسف النجار”، بطل الرواية، إلى “الشيخ حسني” الكفيف، وجعل الأخير والدا ليوسف رغم أنه ليس كذلك في الأصل، ولعله رأى في عجزه رمزا لعجز كل الشخصيات، حيث أن كلا منها تعاني من العجز على طريقتها، وتسعى للتغلب عليه بطريقتها.. وعن ذلك قال إنه حين قرأ الرواية لأول مرة لم يسيطر على تفكيره إلا “الشيخ حسني” رغم المساحة القليلة التي حظي بها في أحداث الرواية، لكنه رأى أنها أكثر ثراء من كل الشخصيات.
وواصل المخرج داود عبدالسيد العمل على مشروعه في فيلمه التالي “البحث عن سيد مرزوق” (1991)، الذي ألّفه بالكامل، وعاود فيه طرح الشخصية التي تتمرد على واقعها البائس الرتيب من خلال رجل يعيش عبدا لوظيفته إلى درجة أنه ينزل للذهاب إليه في يوم عطلة، فيخوض تجارب ومغامرات تنقله إلى الحياة الحقيقية التي عاش حياته محروما منها.
وجاء “سارق الفرح” ليثبت مجددا مهارته كسيناريست، حيث حوّل قصة قصيرة من 18 صفحة إلى عمل درامي كبير، مع الحفاظ على روح القصة كمرثية لبشر يعيشون “عاليا” فوق تلال زينهم لكنهم في الحقيقة في قاع القاع، وسط أكوام القمامة، يتوقون للانعتاق والانطلاق.. سحب صفة الراوي من صاحب “ترابيزة البخت” وأدخلنا عالم سكان العشش وأحلامهم من خلال “ركبة” القرداتي، العاشق الأعرج، الذي “يطير” بعيدا عن واقعه البائس، متحديا عجزه هو الآخر، مستخدما نقراته على طبلته البائسة، معطيا الإيحاء بالوصول إلى ذروة النشوة الجنسية دون أن يلمس حبيبته ودون حتى أن يقترب منها في مشهد فارق لا يُنسى.
وفي ثلاثة أفلام تالية تولى تأليفها بالكامل، “أرض الخوف” (2000) و”مواطن ومخبر وحرامي” (2001) و”رسائل البحر” (2010)، أضاف داود إلى عالمه / مشروعه الأثير أسئلة وجودية واضحة لا تحتمل لبسا، سواء من خلال “آدم”، الذي يعيد قصة نزول الإنسان إلى الأرض وحيدا حائرا في الأول، أو “المواطن” الذي يختار المؤلف أن يكون الروائي المثقف الواقع بين طمع “الحرامي” وعصا السلطة في الثاني، أو الشاب قليل الحيلة الباحث عن الرزق في مواجهة بحر الحياة في الثالث.
ولابد أن تُذكّرك “تهتهة” بطل “رسائل البحر” بعرج “ركبة” في “سارق الفرح”، ولدغة “نرجس” في “أرض الأحلام”، وعيني “حسني” المظلمتين في “الكيت كات”.. كلها رموز لعجز يسعى الإنسان للتغلب عليه في عالم لا قِبل له به.