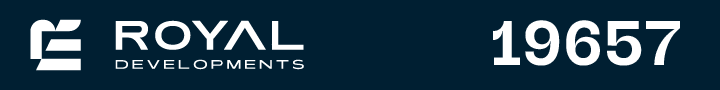بدأت الكتابة مبكرا ، إذْ كان البيتُ مؤهلا لكي أكون شيئًا في الكتابة ، الفقد المُبكِّر لأمي ، العزلة التي أنا فيها ، اهتمام أبي بي ، وحثِّي وتشجيعي على القراءة ، وإغرائي بالمال كلما قرأت كتابًا وسردتُ محتواه عليه ، وتعرُّفي المبكِّر إلى القرآن والنصوص المقدسة الأخرى خصوصًا الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية ، حفظي المبكر لكثير من الأمثال والأغنيات الشعبية ، والطريقة الشاذلية في التصوُّف ، والموالد والعشق فيها على طريقة ” أختي في الله ” ، ومقام سيدي علي السقا ، الذي يبعد دقيقة واحدةً عن بيتنا ، وما كان يدور فيه من طقوس خاصة وكرامات ، وقريتي ( كفر المياسرة ) بشكل عام هي قرية علم وثقافة ومعرفة.
كما أن لها موقعا جغرافيا فريدا ، رغم أنها تقع على شمال السماء ، فإن النيل يحضنها من ثلاث جهات مع أنها ليست جزيرة ، وتعد حسب علمي القرية الأولى التي أخذت من النيل برضاه ومحبته ساحلا ممتدًّا شهد غرقى كثيرين ، رأيتهم في طفولتي وصباي ، لفرط إغراء النيل للمولعين به.
وما أعرفه أنني جمعتُ أوَّل كتابٍ شعري لي وأنا في المرحلة الإعدادية ، طبعه جارٌ لنا كان يكبرني بثلاث سنوات بطريقةٍ بدائيةٍ في نسخٍ محدودة لي ، لكن هذه النصوص لم تُنشر لي في كتاب بعد ذلك ، وأعتبرها من كتابات الطفولة ، والتمهيد لما سأكون عليه بعد ذلك ، لكن طفولتي الغنية بالألم والوحدة والخجل والاهتمام بما هو غرائبي وعجائبي كالمردة والجن والسحر والتوَّاه ، وتربية دود القز ، وصيد السمك ، والثعابين البرية ، وتأمُّل النيل القريب من بيتنا ، ورؤية عشرات النساء عاريات يستحممن فيه ، دون أن يخجلن منا نحن الأطفال ، أو من عابري الطريق ، الذين لا يمكن لأحدٍ منهم أن يلتفت يُسرةً أو يمنةً ليختلس نظرةً لأنه يدرك أن أمه أو أخته أو جارته أو ابنته أو زوجته قد تكون واحدةً منهن.
والذهاب إلى الغيطان بشكلٍ دائمٍ وزراعة جسور أرضنا بالأشجار ، التي راقبتها كطفل وهي تكبر أمامي ، وصيدي لثمار البشنين ( ثمار زهور اللوتس ) من الترعة المحاذية للأرض ، وولعي بالحب رغم خجلي من النساء وقتذاك ، جعلني في نقطة الدوائر التي تشكِّل رُوح إنسان يسعى إلى أن يكون شاعرًا .