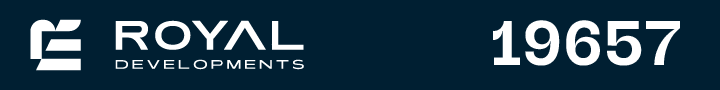كان الألم شديدا. لا يسري بعظامه إلا في الرابعة فجرا كل يوم. يوقظه وهو الذي اعتاد النوم قبلها بساعتين من أعذبها نومة.
لا يتفشى النغز من مركز الوجع بخده الأيمن -لما الأيمن!!! يعلم الله وحده وطبيب الأسنان الذي لن يزوره خوفا من مثقاب الضروس الكهربائي، يعلمان السبب- لا يتفشي من هذا الخد إلى كتفه وجانب وجهه ونصف جمجمته إلا في الرابعة والنصف. وضع جدولا للمرض. كذلك للعلاج. حفظ مواقيته المتكررة.
“تسويس وصل للعصب”..افتراض يفترضه ويتبين فيما بعد أنه خاطئ، يدفعه إلى إذابة كيس الكاتفاست ذي اللونين أبيض وبرتقالي في نصف كوب ماء زجاجي وتجرعه في رفعة يد واحدة .
مرت دقيقة.. مرت دقائق – كما تغني أنغام في الركن البعيد الهادئ- الوجع ثقيل الظل يأبى الرضوخ والانزواء.
يتفتق عقله عن اقتراح باثولوجي جديد ” هو ارتفاع الضغط لا عجب” . تمتد نفس الكف التي أفرغت بودرة العقار السابق المضاد للصداع النصفي بالكوب إلى نفس الكوب. لا زال بقية من الشربة السابقة في قعره، يدفع بواسطتها حبة “توكمانين” لبلعومه. تنشد أنغام دقائق جديدة.
نحن في الخامسة والنصف والصراخ لم يعد مكتوما بحلقه. تغلي دماء بركانية في مسارات أوردته. يود لو دق بمطرقة خشبية عتيقة فوق صدغه أو ينتزع في لحظة بأس السن المخترب المزعج بكماشة حديدية سوداء. لا يفعل خوفا أو تحسبا لما سيعقب ذلك من تشوه لهيئته وتكاليف طبية سيتكبدها لإصلاح وترقيع ما أفسده بوجهه. يعثر على الحل أخيرا . تخمين جديد كسابقيه “إنه البرد لا جدال. أول أكتوبر. موعد الأمراض الرذلة الدوري”..
تسقط كبسولة كومتركس أو كونجستال أو بانادول من عل إلى شقيقاتها من الأدوية بمخزن معدته عبر المرئ وتنتابه رعدة فزع بلا ارتعاش. يخشى دائما من تفاعل كيميائي بين دوائين يودي به للهلاك. يعيش بمفرده في شقته الجديدة بمدينة العبور. عمارة خاوية من أنس الجيران وحارس عقار نائم كضمائر أمناء المكاتب لن يسمعه إذا علت استغاثاته مع استفحال الغيبوبة.
ترك كل هذه الأوهام واقترب من ثلاجته الخضراء. تنبعث سخونة من صاجها. ينجذب كبرادة حديد ممغنطة إلى جسمها الخارجي المتوهج. أخبرته قوة علوية غامضة وطيبة أنه حين يلامس الحرارة الرائعة سينصلح الوضع ولا حاجة “لاستغلال الصيدليات وجشع التجار” كما ينادي بائع الأحزمة في عربات المترو. حين أتمت الساعة السابعة إلا الربع صباحا كان الألم قد زال وكان هو قد غفا واقفا مرتميا بنصفه العلوى على الصاج المشتعل.
تدفق ترياق لاهب من ثلاجته إلى تضاريس الوباء الغامض في رأسه فبدده وبخره. شكر القوة العلوية الناصحة ونام مطمئنا، بينما خليط العقاقير في أحشائه لا يجد ما يعالجه. بطالة مقنعة جعلت كل دواء منهم يسأل: لماذا بعث بنا الرجل إلى تلك الأرض الحمضية المخيفة؟
في الشوارع تكثر الكولديرات والأسبلة التي لصق فوقها مجهولون صورا للشعراوي وأنطوني كوين -في دور عمر المختار أسد الصحراء-. لهاجس ديني ينحو هو -حين يضربه الألم مجددا لكن خارج بيته- بعيدا عن الصورتين لازقا جبهته وأنفه و ما تحت عينه وأذنه وذقنه وحد رقبته وتكويرة كتفه على الجانب الخاوي من الملصقات.
يتمتع بالدفء والنار المعدنية والأمل في شفاء سريع. يمر المارة ما بين ساخر ومندهش وخائف، لكنهم يشتركون معا في لفظ كلمة ” مجنون”.. لا يبالي. يتناول الكوب المسلسل بجنزير ويشرب ماء بلا كبسولات أو حبوب أو مساحيق ذائبة. في امتنان عميق، كخزانة رأسمالي تجاري كندي، يلهج شاكرا الرحمن “سبحان الذي سخر لنا هذا”. يبتسم -بعد ما طاب- دون تكلف في وجه الشيخين ويمضي في طريقه