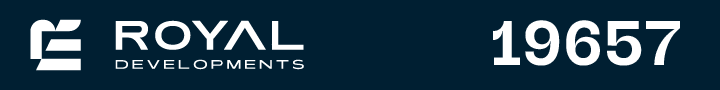ذات يوم قريب طالعت مقالا لأخي الدكتور عادل محمد أحمد الحسيني جعله من باب ما لم يُسَمّ فاعله ، فلم يذكر اسم من نقله عنه ، وبعد قراءته واعتصار قلبي ألمًا حاولت مشاركة منشوره فوجدته ـ سامحه الله ـ قد ألغى خاصية المشاركة ، فقمت بنسخه لأعيد نشره كما هو .
يقول ـ سلمه الله وأعزّه ـ :
إلى أبنائي الأعزاء وإلى إخوتي وأخواتي وأبنائهم وكل المفتونين لدرجة العشق بأمثال مودريتش وميسي ورونالدو وامبابي وهالاند وغيرهم .
رجاءً حارًّا قراءة هذه القصة الطويلة فهي تستحق والله أن تُقرأ واعتبروها استراحة بين شوطي مباراة.
بعد مباراة البرازيل غنّى لاعبو كرواتيا بما فيهم العجوز مودريتش أغنيةً تحيي ذكريات مجازر الكروات ضد إخواننا بالبوسنة .
منذ يومين نشر أحدُ الأفاضل مقالًا سأكتفي بنشره، منذ قرأته، والقلب يُدمي، إلى الله مشتكى أمةٍ هلكى تكالبت عليها الأمم…
————— * * * * *
حين سافرتُ إلي فرنسا سعدت حين اكتشفت أن لي جارًا مسلمًا في المبني الصغير الذي أقطن به. عشت في المبني شهرين دون أن أعرف عنه شيئًا سوي أنه إنسان مهذب صموت لا يتدخل فيما لا يعنيه وكانت العلاقة بيننا لا تتعدي تحية المساء حين ألقاهُ علي السلم وأنا صاعد إلى داري بعد عودتي من العمل. بشكل ما شعرت أن هذا طبعي بالنسبة لفكرتي عن الغربيين بأنهم قوم لا يتدخلون في شئون غيرهم.
في إحدى المرات وبينما أنا أوقع في الكشف الخاص بالمبلغ الذي يدفع شهريًّا لتنظيف المبني الذي أسكن فيه – وهو المبلغ الذي يشترك فيه السكان جميعًا– وجدت أن هناك من يدعي (علي). سألت الرجل المسئول عن المبني – وهو مزيج من حارس وعامل نظافة ونجار وكل ما يخطر ببالك من حرف يدوية – عن كنه هذا الـ (علي) فأشار الي الشقة المقابلة لي. إنها شقة ذلك الصموت المهذب.
عندها زاد فضولي. هل هو مغترب مثلي؟ انا لم أتبادل معه جملة واحدة تضم أكثر من ثلاث كلمات منذ أن سكنت هنا فلا أستطيع أن أميز لهجته من لهجة الفرنسيين، دعك من أنني لست فولتير، أنا أتكلم أشنع فرنسية يمكن أن يتكلمها إنسان علي وجه الأرض وبالتالي فإني لن أميز اختلاف اللهجات بسهولة.
ثم إني خلال الشهرين الماضيين لاحظت أن الغربيين ليسوا جميعًا صموتين انعزاليين مثله كما كنت أظن. هناك من يتشاجر مع شركائه في المسكن، هناك من يخرج من البيت وقد طلا وجهه بألوان العلم الفرنسي ليذهب مع رفاقه لتشجيع منتخب كرة القدم الفرنسي في إحدي المباريات وسط كثير من الصياح والهتاف. سلوك هذا الـ (علي) ليس هو السلوك الغربي التقليدي بل هي طباعه الشخصية.
* * * * * *
أحد أنواع البجع يسمي البجع الأخرس. في الحقيقة هو ليس أخرس ولكن الصوت الذي يصدر منه قليل مقارنة بباقي أنواع البجع المزعجة عالية الصوت.
* * * * * *
في أحد الأيام كنت خارجًا في طريقي إلي العمل وقابلته وهو يغلق باب شقته تمهيدًا للنزول. استغللت الفرصة وألقيت عليه تحية الصباح وعرفته بنفسي وبالتالي صار عليه أن يعرفني بنفسه كنوع من الرد علي هجمة التعارف التي هجمت بها عليه.
عرفت أنه مسلم من البوسنة في الخامسة و الثلاثين من عمره وأنه يعمل محاسبًا في متجر عملاق من المتاجر التي تبيع كل شيء وأي شيء. كان المحل شهيرًا للغاية ويقع قريبًا من المنزل و كما توقعت كان في طريقه إلي العمل. أخبرته أن المتجر في طريقي مع أنه لم يكن كذلك ولكني كنت أستغل الفرصة التي سنحت لي لأتبادل معه بعض الكلمات.
في الطريق تبادلنا بعض الكلمات البسيطة عن الأحوال العامة للبلاد، عن مباريات كأس العالم التي اكتشفت أنه لم يكن يتابعها إطلاقًا و عن المبيعات في المتجر الذي يعمل به. كان حوارًا عاديًّا من الذي يمكن أن يدور بين غريبين في الحافلة، لا هدف له ولا عمق وسرعان ما ينساه المرء في ثوان.
تدريجيًّا توطدت علاقتي به. كنت أزوره أو يزورني مرة كل أسبوع تقريبًا لنتكلم سويًّا و ربما نلتهم العشاء معًا. خرجنا معا لنتنزه معًا مرة أو اثنتين تقريبًا. كان إنسانًا هادئًا مهذبًا وكان علي قدر لا بأس به من الثقافة تعجبت من وجودها في بائع. كان يتكلم بلهجة هادئة مهذبة لا انفعال فيها وعادة ما يستمع إليّ أكثر مما يتحدث.
سألته ذات مرة لماذا ترك البوسنة وجاء إلي فرنسا وخصوصًا أن الحرب قد انتهت منذ سنوات. تغير وجهه وتجمدت النظرة في عينيه وشرد قليلًا ثم قال في اقتضاب:
-“جئت للعمل”.
-“ألم تجد عملًا في بلادك؟”.
-“وجدت ، ولكن الحياة هنا أفضل”.
هنا أدركت أنه لا يريد أن يخبرني السبب الحقيقي الذي ترك بلاده من أجله. أنا غير متابع لحالة بلاده حاليا. ربما كانت الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية في بلاده متردية بسبب الحرب السابقة أو ربما كان هناك سبب آخر لا أعلمه.
في أحد الأيام عندما عدت من العمل في المساء فكرت أن أطرق باب علي وأدعوه للعشاء معي. طرقت بابه ففتح بعد دقيقتين تقريبًا.
-“السلام عليكم. كيف …”.
بترت عبارتي حين رأيت وجهه الشاحب و بقايا الدموع في عينيه.
-“ماذا هناك؟ ما الذي حدث؟”
نظر لي و كأنما يبحث عن رد ثم قال: تدخل.
قالها وأدار ظهره لي ودخل إلي شقته. تبعته حتي الردهة التي يستخدمها كغرفة معيشة. كان جهاز التلفاز مفتوحًا وكان يذيع برنامجًا سخيفًا لا أتذكر موضوعه.
جلس “عليّ” علي الأريكة المفضلة له ورفع قدمه علي الأريكة وأحاط ساقيه بذراعيه وضم ساقيه إلي جسده. بدا لي هشًّا ومحطمًا إلي أقصي درجة.
بدأ “علي” كلامه دون كلمة أخري مني، فقط أمسكت بجهاز الريموت كونترول وأغلقت التليفزيون الذي لم يكن يحظي بأي متابعة.
* * * * * *
تقول الأسطورة الغربية القديمة: “إن البجعة الخرساء تعيش طوال عمرها دون أن تصدر صوتًا حتي تأتي لحظة موتها، عندها تشدو بأغنية غاية في العذوبة والحزن قبل أن تموت.”
* * * * * *
منذ سنوات كنت أعيش في البوسنة. كنت أعمل بائعًا في محل صغير وفي نفس الوقت كنت أدرس اللغة الإنجليزية و الأدب الإنجليزي في الجامعة. لم أكن غنيًّا و لكني كنت راضيًا ومنكبًّا علي دراستي التي كنت أحبها حقًّا. كنت أعيش مع أمي العجوز و لم يكن لي إخوة و قد تُوُفِّي أبي منذ صغري و علي الرغم من هذا لم أكن أرى نفسي بائسًا أو محرومًا.
تدريجيًّا بدأت أنتبه إلي إحدي الفتيات التي تسكن بجوارنا في نفس الحي، في أحد الشوارع القريبة من بيتي. لا أعلم ما الذي لفت انتباهي لها. لم تكن ذات جمال خارق ولكن وجهها كان مريحًا ، به الكثير من الرقة وشيء يبعث علي الكثير من الاحترام.
عرفت فيما بعد أن اسمها “أمينة” وأن أمها هي إحدي معارف أمي. في مثل المناطق البسيطة التي نعيش فيها يعرف الناس بعضهم بعضًا وتتواصل بينهم العلاقات الاجتماعية بسهولة. ذات يوم زارتنا أمها و كانت الفتاة معها. في أثناء الحوار تطرقت أمي إلي حبي للكتب والقصص فسألتني “أمينة” عن الكتب التي أقرأها. اكتشفت أنها هي الأخري مهتمة بالأدب والقراءة وأنها متابعة جيدة للأحداث التي تقع في العالم.
تدريجيًّا وجدت نفسي أفكر فيها وفي الكلمات التي تبادلناها سويًّا في هذا اللقاء. كان شعورٍا جميلًا أن تجد كل اهتماماتك قد تضاءلت لتحل محلها صورة فتاة ما. كنت أقرأ بمعدل كتابين في الشهر علي الأقل فصرت كلما أفتح كتابًا أجد نفسي شاردًا أتذكر وجهها وصوتها الرقيق وابتسامتها العذبة. طلبت من أمي أن تطلب لي يد هذه الفتاة من أمها وفي نهاية العام تزوجتها في حفل بكت فيه أمي وأمها وكأنه حفل تأبين لنا لا حفل زواج.
عشت معها ستة أشهر لا تصفها الكلمات. أن يكف المرء عن أن يكون أنا ليصبح نحن. أن تصبح كل أنشطة حياتك واهتماماتك أكثر إثارة حتي لو كان هذا النشاط هو التهام الإفطار لأن هناك من صار يشاركك هذه الأنشطة والاهتمامات. لم أكن أحب النهر كثيرًا و أتعجب للناس الذين يتنزهون علي ضفافه وكأنه لا توجد أي نزهة أخري سوي السير علي ضفافه و لكن “أمينة” علمتني أن أحبه، أن أحب ضوء الشمس الذي يترقرق علي مائه وأن أحب الطيور التي تهبط علي ضفتيه. كنت أري الأشياء بعينيها هي وما أجملهما من عينين. عينان قادرتان علي رؤية الجمال والخير في كل ما يحيط بك مهما كان مملًّا أو معتادًا”.
سكتَ قليلًا ثم قال: مثل كل ما هو جميل في الحياة انتهت هذه الأيام، و كانت كلمةُ النهاية هنا هي الحربَ. مثلما يحدث في الأحلام التي تفيق منها لتجد أنك مازلت علي أرض الواقع وأنك لا ولم ولن تطير في يوم من الأيام، أفقنا في يوم من الأيام لنجد أننا أسيران في أحد المعتقلات.
في المعتقل كان يتم فصل النساء عن الرجال فافترقت عن “أمينة” ولكني كنت أراها تقريبًا يوميًّا. التفرقة بين الرجال والنساء كانت في أماكن البيات فقط، أما في الأعمال ـ التي كانت قائمة علي قطع أشجار الغابات وقطع الأخشاب وتصنيفها وتخزينها ـ فكان الرجال يتساوون فيها مع النساء. أمام عيني كنت أري “أمينة” تقوم يوميًّا بقطع الأخشاب وحملها علي كتفها في الشتاء القارس. لم أكن أستطيع أن أقدم لها أي عون من أي نوع لأن هذا كان كفيلًا بإثارة “ليوبيناس” وزبانيته وغالبًا سيكلفونها بمزيد من العمل.
لم أستطع يومًا أن أرفع عيني في عينيها. كنت دائمًا شخصًا ثوريَّ الأفكار وكنت أناقش معها أفكار “جيفارا” بحماسٍ أقربَ إلي الجنون، والآن أنا ظهرت علي حقيقتي، مجرد شخص عاجز عن أن أدافع عن نفسي أو عن الفتاة الوحيدة التي خفق قلبي لها. عاجز حتي عن أن أساعدها في حمل الأخشاب وتقطيعها. انا مجرد إنسان فارغ يجيد الكلام و لكنه يجبن حين يري أول مدفع رشاش يوجه لصدره.
ذات مرة رأيت “أمينة” تقطع الأخشاب وترتجف من شدة البرد فلم أستطع أن ألتزم بتحفظي ومحاولتي أن لا أُظهِر أيَّ علاقة بيننا. اتجهت إليها و نزعت معطفي ووضعته علي كتفيها دون أن أتبادل معها كلمة واحدة. استدرت عائدًا إلي عملي فاستوقفني صوت مدير المعتقل الذي رأي ما فعلته.
كان وحشًا يُدعَى (راديسلاف ليوبيناس). سأظل أتذكر هذا الاسم ما حييت. أوقفنا بجوار بعضنا وسألني عن علاقتي بها. أخبرته بأنها زوجتي فارتسمت علي وجهه ابتسامة صفراء و طلب من أحد الجنود مدفعه الرشاش. تصورت أنه سيقتلنا وتمنيت أن لا تتألم “أمينة” كثيرًا. أعطاه الجندي مدفعه فأمر “ليوبيناس” “أمينة” بأن تنزع المعطف وتضعه علي الأرض. في البداية لم أفهم لماذا. ما إن فعلت “أمينة” هذا حتي خفض “ليوبيناس” فوهة مدفعه الرشاش وأطلق سيلًا من الرصاصات علي المعطف الملقي علي الأرض ليحيله خرقة بالية من القماش. ارتجفت “أمينة” لصوت الرصاصات المفاجيء وشعرت بالشفقة تجاهها تغمرني للمرة الألف منذ أن بدأ هذا الكابوس.
نظر لي “ليوبيناس” نظرة شامتة وقال: “ها قد ذهب المعطف، لن يناله أيكما”.
ثم أشار بفوهة مدفعه الي كومة من الخشب الملقاة علي الأرض وقال لي:“ضعها علي كتفها”. نظرت إلي كومة الخشب فوجدتها كومة ضخمة ثقيلة لا أستطيع أن أحملها أنا علي كتفي. نظرت إلي أمينة فهزت رأسها إيجابًا و في عينيها ترجوني أن لا أرفض. الرفض لا مقابل له هنا سوي القتل.
حملت كومة الخشب بصعوبة بالغة ووضعتها علي كتف “أمينة” وأنا أضع عيني في الأرض. لم أستطع أن أرفع عيني في عينيها وأنا أفعل هذا.
حملت أمينة كومة الخشب و سارت بها باتجاه المخزن الذي يتم فيه تخزين الأخشاب. لم تتحمل ثقل الأخشاب وتعثرت بعد أن سارت بضع خطوات وسقطت أرضًا.
سالت الدموع من عينيه وبدأ صوته يتحشرج.
-انفجر “ليوبيناس” وجنوده في الضحك وهرعت اليها و ضممتها بين ذراعي وبكيت و بكت هي لأول مرة منذ أن دخلنا المعتقل.
في الأيام التالية بدأت صحة “أمينة” تسوء. كانت تشحب وتفقد الكثير من وزنها يومًا بعد الآخر. في كل يوم كنت أراها كنت أشعر بأنها فقدت عشرة كيلو جرامات من وزنها مقارنة باليوم السابق ومع هذا رفض الأوغاد طلبي بأن يطلبوا لها طبيبًا أو يعفوها من العمل أو حتي يخففوه. الكثير من الأسري يموتون يوميًّا فلن تشكل هي فارقًا إن ماتت.
وقد كان
ذات مساء شعرت بيد غليظة تهزني بعنف. فتحت عيني لأجد أحد الجنود هو الذي يوقظني. قال لي :
-“الجنرال يأمرك أن تأتي لتدفن زوجتك”.
هكذا بمنتهي البساطة و بلا أدني انفعال، فلو كان يأمرني بأن أقوم بتنظيف العنبر الذي ينام فيه المعتقلون لبدا في صوته انفعال أكثر من هذا.
قمت و أنا أشعر أن هذا كابوس وأن الأمر لا يمكن أن يكون حقيقيًّا. تبعته كالمنوَّم مغناطيسيًّا حتي القسم الذي يضم النساء في المعتقل. وجدت “أمينة” مسجاة علي أحد الأسرة وعلي جسدها أغطية بسيطة لا تكفي لتقي من البرد القارس. حول فراشها تجمعت بعض النسوة و الدموع تسيل من أعينهن في صمت. مع أن الموت هنا غدا شيئًا عاديًّا إلا أن موت “أمينة” لابد أن يكون شيئًا مختلفًا بالنسبة لكل من عرفها ولو للحظات.
أمرني أحد الظباط أن أحفر لها قبرًا وسط الغابات في الجليد لأدفنها فيه. لا يوجد موتي اليوم وإلا لدفنت مع الآخرين في قبر جماعي. غير مسموح بأي طقوس للدفن، لولا خوف الضباط من انتشار الأمراض فلربما لم يدفنوا أيًّا من الموتي أساسًا.
حملت جسدها و سرت باتجاه الغابات. كنت مازلت في حالة الذهول تلك منذ أن أيقظني ذلك الجندي من النوم. أتذكر أني وقت ان كنت أحفر لها قبرها وسط الجليد وأقوم بدفنها لم أكن أدعو الله لها بالمغفرة أو الرحمة فقط لم أكن أردد سوي (سامحيني فليس بيدي ما أفعله). كنت أرددها بلا انقطاع فلو رآني أحدهم لأقسم بأني مجنون.
لم أبكِ إلا حين عدت الي فراشي. بكيت بلا انقطاع حتي أشرقت الشمس في صباح اليوم التالي. عندما ضرب النفير لإعلان بدء يوم جديد من العذاب مسحت دموعي وعشت كالآلة منذ ذلك اليوم وحتي انتهت الحرب و خرجت من المعتقل. كنت أفعل ما يطلب مني دون أي مشاعر. لم أكن أشعر بالبرد أو الإجهاد أو الحزن أو القلق.
بعد انتهاء الحرب بحثت كثيرًا عن أمي فعرفت أنها تُوُفِّيت هي الأخري في أحد المعتقلات الذي لم يكن يبعد عن هذا الذي كنت فيه أكثر من بضعة كيلو مترات. تمنيت أن تكون قد ماتت سريعًا ولم تعانِ طويلًا.
بعد هذا شعرت بأني عاجز عن أعيش في البوسنة أكثر من هذا. لا أريد أن أري النهر ولا أريد أن أري الأماكن التي عشت فيها لأنها كلها تذكرني بـ “أمينة”، بل ولا أريد حتي أن أسمع عن أي فتاة اسمها “أمينة”. جئت إلي فرنسا وعشت لسنوات أحاول أن أنسي الماضي وآمل أن أموت يومًا فأقابل “أمينة” في العالم الآخر. عندها سأجثو علي ركبتي وأقبل يديها وأطلب منها أن تسامحني وتغفر لي”.
لم أستطع أن أحكم فضولي فقاطعته:
-“لماذا لم تسافر إلي إنجلترا مثلًا؟ أنت تقول إنك درست الأدب الإنجليزي فمن المنطقي أن تسافر الي دولة تتحدث الإنجليزية”.
مسح دموعه ونظر لي واجمًا للحظات وكأنه لم يتوقع السؤال ثم قال:
-“كانت فرنسا أول فرصة سفر سنحت لي. لم أفكر ولم أختر ، فقط كنت أفر من كل ما يربطني ببلادي وما يذكرني بأمينة”.
سكتَ قليلًا فاحترمت صمته لبعض الوقت ثم قلت:
-“لماذا تذكرت “أمينة” الآن بالذات؟ هل اليوم هو ذكري زواجكما أو وفاتها؟”
هز رأسه نفيًا وأكمل قصته:
-“حين عشت هنا تابعت أخبار مجرمي الحرب الصرب الذين كانوا يقدمون للمحاكمة وعرفت أن “راديسلاف ليوبيناس” أحد المطلوبين للمحاكمة ولم يتم العثور عليه إلا منذ فدة قليلة. حاولت أن أتابع أخبار محاكمته ولكن للأسف لم تتم إذاعة كل المحاكمات علنًا.
قاطعته في انفعال:
-“محاكمة قادة النازي كانت تذاع في السينمات في أوروبا حين لم يكن هناك تلفاز”.
أشاح بيده وكأن الأمر لا يهمه وأكمل: رأيت له صورة واحدة فقط في الجرائد. نفس النظرة الواثقة والبرود العسكري، فقط زاد عدد الشعيرات البيضاء في شعره”.
أشار الي التلفاز وقال:
“اليوم تم النطق بالحكم عليه فما الحكم الذي تتوقع أنه صدر ضده”؟
فتحت فمي لأرد إلا أنه أكمل وكأنه لا ينتظر مني ردًّا.
-“السجن لعشرة أعوام. تهم بالقتل والتعذيب و ارتكاب المذابح ثبتت ضده وفي النهاية صدر ضده حكم بالسجن لعشرة أعوام يخرج بعدها ليمارس حياته كأي سيد مهذب. هذا الرجل دمرني وحرمني من حياتي السعيدة التي كنت أعيشها مع زوجتي وفعل المثل للكثيرين وفي النهاية يصدر ضده حكم قضائي وكأنه سرق بضعة آلف من أحد البنوك”.
لم أعرف بماذا أرد عليه فأنا لم أكن أتابع هذه القضية ولا أعرف عنها شيئًا. قمت من مكاني وجلست بجواره وربت علي كتفه دون أن أنطق.
سالت الدموع من عينيه مجددًا و قال بصوت مختنق:
-“لو كان في هذه الدنيا عدل لقتل هذا الرجل آلف المرات بعدد من قتلهم ودمر حياتهم”.
قالها وانفجر في البكاء الحار. حاولت أن أهديء من روعه ولكن بلا فائدة. قمت وذهبت إلي شقتي وأخذت شريطًا من الأقراص المنومة التي أستخدمها أحيانًا حين أعاني من الأرق واتجهت إلي شقته. لابد من أن ينام الآن ليتوقف عن التفكير في ما حدث. لو كنت طبيبًا لحقنته بنوع من المهديء ليكون سريع المفعول ولكني لست طبيبًا ولا أعرف كيف يمكنني أن أجد طبيبًا بسرعة الآن.
عندما كنت أمام باب شقته توقفت مفكرًا. ربما يستخدم الأقراص في الانتحار بأخذ جرعة مضاعفة من المنوم. هو لا يبدو لي من النوع الذي ينتحر ولكن الحالة التي يمر بها الآن قد تدفع أي إنسان لهذا.
عدت الي شقتي وتركت شريط الأقراص بعد أن أخذت منه قرصًا واحدًا اتجهت إلي شقة “علي”. كان لا يزال في نوبة البكاء العنيفة هذه فأعطيته قرص المنوم وكوبا من الماء. ابتلع المنوم دون أن يسأل عن كنهه وبعد ساعة تقريبًا بدأ يهدأ وبدأ جفناه يسقطان. سحبته من يده إلى غرفته وجعلته يستلقي في الفراش وسحبت الأغطية علي جسده. تدريجيًا بدأ يغيب في النوم وهو يردد بلا انقطاع:
“لا أريد أن أعيش في هذا العالم”.
شعرت بالشفقة تغمرني تجاهه وفكرت في أن أقضي الليل بجواره إلا أني أعرف مفعول هذه الأقراص. لن يستيقظ قبل ثماني ساعات علي أقل تقدير. يمكنني أن أمر عليه غدًا في أي وقت فغدًا يوم الراحة الأسبوعية لي.
في صباح اليوم التالي طرقت بابه فلم يفتح لي. شعرت بشيء من القلق إلا أني عزوت الأمر لقرص المنوم الذي أعطيته له. لابد أنه مازال نائمًا.
بعدها بثلاث ساعات دققت جرس الباب فلم يفتح. هنا بدأت أشعر بالقلق. طرقت الباب بعنف ولا مجيب. لا أريد أن أبلغ الشرطة ثم يظهر في النهاية أن قرص المنوم هو السبب. نزلت الي حارس العقار وطلبت منه أن يصعد معي ليفتح شقة “علي” لأنه لا يرد منذ ساعات. في الغرب يحمل حارس العقار نسخة من مفتاح كل شقة في المبني تحسبًا لظروف الطواريء والحوادث.
صعد معي الحارس وفتحنا باب الشقة ودخلت متوقعًا الأسوأ. وجدت “عليًّا” في فراشه كما تركته منذ أمس. هززته وناديت اسمه فلم يستيقظ. لطمت خديه برفق ثم بعنف ولا فائدة. اللعنة.
طلبت من الحارس أن يطلب الإسعاف لأني جديد هنا ولا أعرف أرقام الطواريء. بعد دقائق تعالى صوت سارينة الإسعاف المولول وجاء اثنان من المسعفين ومعهما طبيب شاب فحص علي سريعًا ثم نظر إلي وقال في أسف:
-“لقد مات”.
نظرت له مذهولًا. لا يمكن أن تكون جرعة المنوم هي السبب فأنا آخذ نفس الجرعة منذ سنوات. بعد لحظات من الصمت قلت له:
-“هل أنت متأكد”؟
حدق في مندهشًا وكأنه لم يتوقع سؤالًا كهذا ثم قال: بالتأكيد”.
-“وما سبب الوفاة”؟.
-“لا توجد أي علامات واضحة. غالبًا هي سكتة قلبية ولكن لا يمكنني أن أجزم دون فحص دقيق”.
فيما بعد أثبت الفحص سلامة تشخيص الطبيب الشاب لقد مات “علي” في هدوء، وكأن الله قد استجاب لرغبته بأن لا يحيا في هذا العالم الظالم الذي حرم فيه من زوجته وأمه وذكرياته دون سبب ودون أن يلقي من دمر حياته جزاءه.
لقد كانت القصة الأخيرة التي التي رواها “علي” هي أغنية البجعة التي شدت بها بعد أن عاشت طوال عمرها صامتة لا تنطق.
ملحوظة: “راديسلاف ليوبيناس” شخصية حقيقية، وقد قام بارتكاب مذابح وجرائم ضد المسلمين المدنين في البوسنة وفي النهاية تم الحكم عليه في عام ٢٠٠٧ بالسجن لعشر سنوات فقط.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير